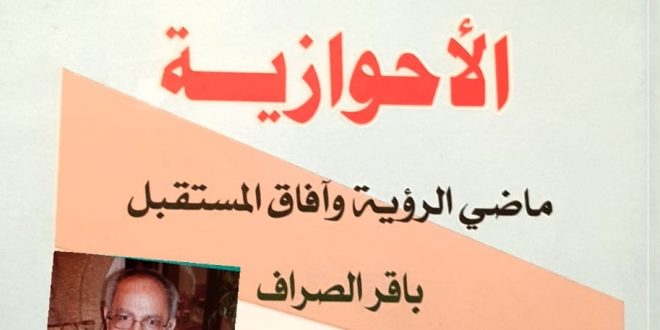بقلم: الباحث والكاتب القومي العروبي الفقيد باقر الصراف
الفصل الأول
لمحة تاريخية عن القضية الأحوازية
ـ 1 ـ
قبل باديء ذي بدء ، ينبغي علينا تحديد المفهوم السياسي والفكري للقضية الوطنية الأحوازية، كون المفهوم غير الكلمة المجردة التي هي عبارة عن حروف ومعنى لغوي، كأي كلمة لغوية أو أدبية تحتويها القواميس اللغوية، إذ من “المعلوم أنَّ الكلمات المجردة لا تستلهم حيويتها إلا من المقام ولا تكتمل معانيها إلا داخل السياق اللغوي الذي ترد فيه”، كما يقول الفلاسفة اللسانيون، ولكن مع ذلك، فهناك من الكلمات ما يدلُ معناها اللغوي على العكس من مفهومها السياسي، فلو أخذنا كلمة “الإستعمار” من حيث معناها اللغوي المجرد عن معناها “المفهومي”، نكتشف الفارق النوعي بين المعنين اللذين ينطويان عليهما مضمونهما. فالإستعمار بالمعنى اللغوي يتضمن معنىً إيجابياً يحددة كتاب المنجد في اللغة والإعلام على الشكل التالي :”إستعمره : في المكان، جعله يعمره ، كقوله “إستعمر الله عبادَه في المكان” أي طلب منهم العمارة فيها. [1] .
أما “المعنى المفهومي” لكلمة الإستعمار فينطوي على معانٍ سلبية واضحة، بل تعني على وجه التحديد قيام دولة معينة “بإحتلال أرض أجنبية من قبل سلطة سياسية ـ عسكرية غازية، فيُدعى البلد الغازي {بالمتروبول} والبلد الذي تعرض للغزو يصبح مُستعمرَة”، [2] . وإذا كان المعنى اللغوي المجرد قد تبلور مع نشوء اللغة منذ صيرورتها أداة للتفاهم بين أفراد الشعوب بعضهم مع البعض الآخر، إلا أنَّ المعنى المفهومي لكلمة الإستعمار إقترن بقوة مع المرحلة الإستعمارية الحديثة للبلدان الأوربية وسـياسـات المزاحمة الحرة بين الدول الرأسمالية التي غزت العالم غير الأوروبي منذ “القرن الخامس عشـر حتى منتصف القرن العشرين، [. . .]، وقد برزت الظاهرة “الإستعمارية في مطلع العصر الصناعي، كحاجة لتزويد المجتمعات الصناعية بالمواد الأولية ولتصريف منتوجها في البلدان الأجنبية”، [3] .
لماذا نتطرق إلى هذه المقدمة التي نراها ضرورية ونابعة من طبيعة الموضوع المبحوث لاحقاً ؟
لأنَّ هناك مفاهيم تفسيرية متفاوته حول كلمة أو مفهوم الأحواز بحكم التقادم الزمني المديد للمنطقة، أولاً، والطبيعة القومية للقوى المسيطرة على هذا الجزء من الوطن العربي، بحكم التاريخ والجغرافية والتحدر اللغوي والعرقي السامي أو الآري، ثانياً، وكثرة الأطراف المتنازعة حول عائدية المنطقة للشعب المحدد، فهناك مَنْ يطلق عليها ألأحواز أو الأهواز، وهي ألفاظ تستخدم بكثرة من قبل أطراف متعددة : قد تكون متناقضة التوجهات الفكرية والسياسية. وعندما راجعنا القواميس اللغوية لم نجد لكلمة الأهواز وجود أو معنى، وإنْ إستخدمت تاريخية منذ فترات سحيقة غاية في العمق التاريخي، ربما إمتدت إلى المراحل إلى العهد الإسكندر المقدوني، ولكن ما هو متوفر هي كلمة الأحواز، فوق كونها تستخدم في العديد من الأقطار العربية ، ومن بينها أحد الأسماء التي تشير إلى أحد الأهوار بإسم “هور الحويوة” المتفرع عن نهر دجلة ويقع ما بين منطقة الأحواز وجمهورية العراق .
في كتاب المنجد في اللغة والإعلام لم نجد أية كلمة ترتبط جذورها التركيبية بكلمة الأهواز، بينما وجدنا كلمة الأحواز لها إمتدادات لغوية متنوعة، فنتلمس كلمة ـ على سبيل المثال ـ :”حاز {وتفرعاته اللغوية} تعني كلها ضمه وجمعه، حصل عليه. الحوز : الموضع إذا أقيم حواليه سد أو حاجز. حوز الدار: ما إنضم إلها من المرافق والمنافع . الحوزة : الناحية . حوزة المملكة : ما بين تخومها. الحْيز والحيِّز : المكان وهو مأخوذ من الحوز أي الجمع، يقال “هذا في حيز التواتر” أي في جهته ومكانه، [4] .
لذا فكلمة الأحواز هي الأنسب في إستخدامها كمفهوم. أما الأهواز فهي كلمة قد تكون ناجمة عن لحنٍ لغوي يمارسه الفرس كون أبجديتهم اللغوية الفارسية تفتقر إلى حرف الحاء المعروف باللغة العربية. أما الكلمات الأخرى ككلمة خوزستان وعربستان فهي تركيب ملفَقٌ: بالمعنى اللغوي، مبني من كلمة إحداهما تدّلُ على العربية والثانية “ستان” غير عربية التي معناها في اللغة الفارسية بلاد، وهي هنا بلاد العرب مثل كردستان وبلوشستان وغيرهما، ولا يليق بأبناء العروبة : والأحوازيون العرب في المقدمة منهم، إستخدامها مطلقاً، إذا كنا مؤمنين بالعمل على نيل حقوقنا السياسية كاملةً، والعمل على إنجاز وتحقيق هويتنا العربية .
إن الكتّاب العرب والشعراء والمؤرخين ، قبل سيادة المفاهيم السياسية العلمية، إستخدموا الكلمتين في مؤلفاتهم، لذا نحن من جهتنا نحبذ إستعمال ما صاغه المؤرخ والعالم الجغرافي ياقوت الحموي الذي أصَّل الكلمة لغوياً في كتابه : “معجم البلدان”، وتدبر في الواقع الإجتماعي لها، إذ يقول : “الحويزة مصغر حوز من حاز يحوز حوزاً، وبالنظر إلى معنى كلمة حوز، فإنَّ سكنة هذه المنطقة كانوا قبل الإسلام موزعين على قبائل وعشائر مختلفة، وكانت كل واحدة من تلك القبائل أو العشائر تضع اليد على أرضٍ مشاع معينة، كونها أرضاً خاصة بها وعائدة لها ، وتميّزها من الأراضي المحيطة بها وتعتبرها حوزاً لها، فكان هناك مثلاً حوز بني تميم وحوز بني حنظلة وحوز كليب بن وائل . تلك كانت أحوازاً مسـتقلة عن بعضها تدير إقتصاداً مغلقاً، وكان مركزها سوق الأحواز الذي ربما كان أكبرها”، [5] ـ ومن المعلوم، أنَّ المعنى المتعارف عليه لـ”لإقتصاد المغلق” هو إقتصاد الديرة التبادلي .
على أنه من الملاحظ إنَّ المفهوم المستخدم للإشارة والتدليل على إمارة الأحواز في كل المراسات الدولية والأجنبية كان مفهوم بلاد العرب : أي إمارة عربستان، تمييزاً لها عن إيران وتحديداً لها، كمفهوم يتداول على مستوى الدول والأمم في العصر الحديث، ويعنون فيه “إمارة مستقلة”، وهي إشارات موحية على عروبة المنطقة، ولها دلائل كثيرة من ناحية المفاهيم السياسية : لعل أبرزها ما ورد في تقارير المخابرات البريطانية التي كانت تتحكم في شؤون المنطقة كلها، [6].
وكانت بريطانية تسيطر على المنطقة الممتدة من هولندا التي تقع في غرب أوروبا ويمتد نفوذها السياسي إلى مناطق الشرق الأقصى قبيل الإحتلال الفارسي للأحواز، لقد إمتد هذا التأثير السياسي حتى زمن الحرب العالمية الثانية ، وكان لها القُدرة على تفكيك وتركيب أوضاع مختلف المناطق التي تخضع لسلطتها السياسية ، وللمدلول اللغوي لكلمة / مفهوم عربستان أهمية تاريخية كبيرة، الأمر الذي دفع الأستاذ عبد النبي قيم لمتابعة نشوئه وصيرورته ومن ثم إلغاء إسـتخدامه في المراسلات الرسـمية الإيرانية، [7]، لصالح الأسماء الفارسية الدالة على هيمنتها .
في أية حال، وكوننا نريد لكتابنا أن يكون كتاباً كفاحياً في هذه المرحلة التاريخية، ويعضد جهود الوطنيين الأحوازيين ومناصريهم من العرب في التحرر الوطني من الإحتلال الفارسي الصفوي، وإنجاز متطلبات مفهوم حق تقرير المصير، ونيل السيادة السياسية التامة، من دون إفتئات على الحقائق التاريخية المتوفرة، وليس على حساب العلوم الجغرافية الراسخة، ومن غير إنكار للمكتشفات الآثارية الهامة، وبالإستناد إلى الوشائج والتطورات اللغوية المرتبطة ببدايات المرحلة االتغريخية للرسالة العربية الإسلامية، فعلينا الرصد التالي .
ـ 2 ـ
ترتبط القضية الوطنية الأحوازية، تاريخياً وجغرافياً بقضية الأمة العربية وتشوف أبنائها المخلصين في التوحد والتطور والتقدم . . . وكذلك في تفاعل أحداث الأحواز السياسية الداخلية مع الأحداث والتطورات السياسية التي شهدها ويشهدها الوطن العربي في العصر الحديث خصوصاً ، فضلاً عن تشابك عواملها التكوينية بروابط اللغة والدين وإشتراك التحدر من العنصر السامي والتماثل في الأساس الجغرافي الطوبوغرافي والمهني الزراعي والإنتاجي .
كانت علاقات أبنائها مع منطقة الخليج العربي والعراق ومجتمعهما قبل إقدام القوات الفارسية على إحتلال هذه البقعة العربية الأصيلة، وبعد الإحتلال أيضاً، علاقات إجتماعية وطيدة متمازجة وشديدة الوشائج، وبالتأكيد في كل أبعادها المترابطة كان لها الأولوية في الترحال والإستقرار للعمل وجلب الرزق، وهي فوق ذلك يرتبط غالبية سكانها بموروث قبلي مشترك من الناحية البيولوجية .
وكم وجدنا بعض العوائل الأحوازية تعد اليوم من المكونات الإجتماعية لتلك البلدان الخليجية العربية، وفي العراق أيضاً، ناهيك عن الوحدانية القبلية على الحدود المشتركة بين كلٍ من دولة العراق وبعض الدول الخليجية، من جهة، والمنطقة الأحوازية المحتلة من قبل إيران الفارسية، من جهة أخرى . إنها إذن علاقة الجزء الأحوازي القطري بالكل القومي العربي الذي يشكل الوطن العربي أساسه المادي المشترك، وتلك هي إحدى خصوصيات المنطقة العربية الممتدة من المحيط المغربي إلى مياه الخليج العربي وبلاد الأحواز شرقاً، وهل كان ترشيح الأمير خزعل للعرش كملكٍ على العراق مجرد مصادفة لا تمتُ بصلة جدلية إلى الحقائق التاريخية والمفاهيم الجغرافية التكوينية ؟ ! .
ولو تتبعنا النسب المئوية للمهاجرين الأحوازيين إلى خارج وطنهم في اللحظة التاريخية الراهنة، وليس قبل سنوات الإحتلال الفارسي لأرضهم في العام 1925 فقط، لوجدنا أنَّ مؤشرات هجرتهم الرقمية تتجه لجوارهم في المناطق العربية كالعراق وفي بلدان الخليج العربي وبعيداً عن إيران. علامَ يدلٌ هذا الإختيار لمناطق الجذب السكاني؟ ألا يدل على التقارب والتمازج الذهني والعاطفي بين مواطنى القطر الأحوازي العربي وأبناء الأمة العربية، ورفضهم الموضوعي للإنخراط في التركيبة الفارسية في طهران وخلافها من المدن الإيرانية، وإختلافهم من حيث العِرق السـامي الذي يتحدرون منه، من ناحية، والعِرق الآري الذي يتناسلون منه الفرس ؟!، من الناحية الأخرى .
كانت الأحواز شعباً وأرضاً تشكل جزءاً تاريخياً من الوطن العربي الذي وقع في براثن التسلط الأجنبي في المرحلة التاريخية التي سبقت نشوب الحرب العالمية الأولى في العام 1914، في العصر الحديث الذي باتت فيه الهيمنة الأوروبية واضحة، فأغلب المناطق العربية وقعت أسيرة التسلط العثماني الذي كان يتخذ من الرابطة الدينية الإسلامية ستاراً لفرض هيمنته على أجزاء هامة من الوطن العربي، ولكن مع سيطرة جماعة “الإتحاد والترقي” وإنسياقها في موجات التعصب الطوراني العنصري، وإصرارها على التتريك اللغوي والوظيفي، [8] .
بل أقرنت الهيمنة العثمانية الإستعمارية تلك السياسة ، بالقمع والإعدام وفرض الضرائب و”السفر برلك” : أي التجنيد القسري في سبيل الدفاع عن تركيا وأملاكها، والنهب اللصوصي لثراتها، وإستباحة المدن: كالحلة في “دكة عاكف”. لقد أغرق العثمانيون العراق في ميادين التخلف والتأخر الذي شمل الميادين كلها، وهي ظواهر ملموسة قد إستفزت مكامن الشعور القومي العربي ، وبدأت مطالبها تتقدم من “اللامركزية” إلى “الحكم الذاتي” إلى “الإستقلال القومي” ، [9] .
وهو ما عمل على إستغلاله دعائياً الإستعمار الأوروبي الحديث : البريطاني خصوصاً ، بعقلية سياسية أشد تطلعٍاً وإرتباطاً بروحية إستغلالية وإستكلابية وذئبية ، فوضع الخطط السياسية المتقنة في سريتها وموهها بحملاته الإعلامية / الدعائية حول التطلاعات القومية العربية للإنفلات من السيطرة العثمانية ، وتم بذلك القضاء على الإمبراوطورية العثمانية وتم التقاسم البريطاني والفرنسي : المنتصرون في الحرب العالمية الأولى ، تركة ما عُرِف بإسم تركة “الرجل المريض” ، [10] .
ولكن هذه الهيمنة العثمانية خلال السنوات الأخيرة من قيمومتها التكوينية ، وخوضها الحروب المتتالية مع “الأمة الفارسية” فوق الأرض العراقية العربية بفعل الدعوات المذهبية الطائفية ، [11] ، لم تقف بوجه الأطماع الفارسية التي كانت ترنو بعيون السيطرة العنصرية على أجزاءٍ من الوطن العربي، وباتت منطقة الأحواز مثلما سيكون العراق تالياً، هي البؤرة التي تمثل حالة النزاع أو الصراع بين الأمتين “التركية” و”الفارسية” اللتين تدعيان الإسلام .