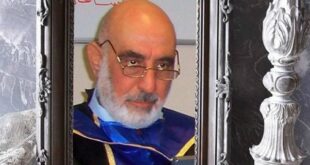ماذا يحدث في اليمن؟
يتساءل المتابع للأحداث عما يحدث منذ سقوط العاصمة اليمنية صنعاء بيد ميليشيات الحوثي وتداعيات الحرب الدائرة فصولها هناك. وبقدرما يبدو الوضع معلوماً وفق ما تتداوله وسائل الإعلام العربية والأجنبية، فإن هناك ما هو مجهول في المسألة اليمنية، لأسباب عديدة منها ما يرتبط بحملة التضليل والتزوير للحقائق، ومنها ما يرتبط بتداول ذلك التضليل والتزوير باعتباره مسلّمات لا تقبل المناقشة.
سأحاول هنا أن أقارب الأحداث في سياقها الموضوعي إجابةً على تساؤل كيفية سقوط صنعاء دون مقاومة، ثم استعصائها على قوات التحالف العربي الداعمة لما يعرف بالشرعية اليمنية المتمثلة بالرئيس التوافقي عبدربه منصور قبل أن تحرق الحرب تلك التوافقية واتفاق السلم والشراكة الموقع بين حكومته والحوثي والأحزاب اليمنية التي تلاشت، كأن لم تكن، تحت غبار المعركة.
(1)
المسألة اليمنية ليست صراعاً حزبياً، أو طائفياً، أو ثورة شبابية بمواجهة نظام سياسي مستبد، كما قد تتراءى أو تُقارب وفق معطيات معينة بخلفيات حزبية أو طائفية أو أيديولوجية، وإن يكن جزء من ذلك صحيحاً، ولكنها نتيجة لتراكم خطايا سياسية يتم الدوران حولها ضمن استراتيجية ترحيل الأزمات التي اعتمدها النظام السياسي في صنعاء والقوى المتحالفة معه. وبعيداً عن التفاصيل التي لا يتسع لها المجال هنا، أشير إلى خطين متوازيين في المسألة اليمنية، يتمثلان في قضيتين رئيستين هما القضية الشمالية والقضية الجنوبية بمفهومهما السياسي، فالأولى تعد تجلياً للخلل العام في طبيعة النظام ومركز القرار والنفوذ وفق تراتبية اجتماعية وسياسية تبطن عكس ما تظهر، فالنظام قائم على تحالف قبلي عسكري تجاري يتخفى خلف واجهة مدنية قبلت بوظيفة الاستخدام المأجور، ويستوي في ذلك من تم استخدامهم من مناطق مستضعفة في الشمال السياسي، ومن تم استخدامهم من أفراد جنوبيين مأجورين في الجهاز الإداري والسياسي. أما الأخرى فهي القضية الجنوبية التي تعد تجلياً ونتيجة لما أفرزته حرب 1994 بين الشمال والجنوب اللذين أعلن نظاماهما السياسيان توحيد الدولتين عام 1990 في إطار دولة واحدة عُرفت بالجمهورية اليمنية التي لم تتجاوز وحدتها مستوى الإعلان، لتسقط كمشروع سياسي سلمي بإعلان علي عبدالله صالح الحرب على الشريك الجنوبي، وما تلا ذلك من اجتياح، واستباحة، وهيمنة مطلقة، واستضعاف، واستلاب القراره السياسي، ونهب الثروات، وإخراج الجنوب نهائياً من الشراكة السياسية السلمية بالقوة العسكرية.
(2)
على إثر احتواء حركة 11 فبراير الشبابية 2011ضد نظام علي عبدالله صالح، تم تحويل الحركة من فاعلية ثورية إلى أزمة سياسية، استطاع من خلالها صالح أن يستعيد أنفاس نظامه ويعيد ترتيب أوراق اللعبة، مادامت الأطراف المواجهة ليست ثورية، وإنما أحزاب وقبائل له تجربة مع قياداتها ورؤسائها في الترويض والاحتواء والموالاة، ثم أتت المبادرة الخليجية لتمنحه طوق النجاة، والاطمئنان على استراتيجية ترحيل الأزمات التي لم يفضِ الحوار الوطني اليمني الذي حظي برعاية إقليمية ودولية إلى حلول جذرية للمسألة اليمنية، لأسباب عديدة أبرزها:
أ – أن أطراف الحوار هي ديكور اللعبة السياسية، فيما اللاعبون الأساسيون خارج الحوار (علي صالح وقوى التحالف القبلي العسكري التجاري).
ب – أن القضية الجنوبية كطرف موازٍ للقضية الشمالية كانت غائبة بمفهومها السياسي عن ذلك الحوار، وقد مورس التفاف عليها بالتعامل معها كقضية مطلبية حقوقية، الأمر الذي أدى إلى ابتعاد مقصود عن الحل الجذري، فضلاً عما عمدت إليه حكومة صنعاء من تزييف تمثيل تلك القضية بأشخاص من مناطق جنوبية لكنهم منتمون إلى مشاريع أحزاب سياسية موالية إما لعلي صالح أو للقوى المتحالفة معه.
لذلك كان الجنوب أول الرافضين لمخرجات الحوار الوطني الذي لم يكن طرفاً فيه، ثم اختلف الفرقاء/الشركاء، على تلك المخرجات التي أقرها من لا يملكون القرار بحسب طبيعة تكوين النظام السياسي في صنعاء، فحدثت تداعيات كبرى كان من نتائجها تحالف علي صالح من خاض ضدهم ستة حروب (الحوثيين)، فكان سقوط صنعاء بطريقة الاستلام والتسليم مفاجأة صادمة للمراقب من الخارج، لكنها كانت تحصيل حاصيل في نظر العارف بطبيعة الأحداث والتحالفات واستراتيجية الحكم هناك.
(3)
إسقاط صنعاء لم يكن هدفاً للحوثي بعيد المنال، لكنه كان وسيلة لإعادة إخضاع الجنوب الذي بدأ يعيد ترتيب أولوياته الوطنية، فشهد ما بعد السقوط توقيع اتفاق السلم والشراكة بين بقايا نظام صالح وأحزاب صنعاء السياسية والحوثي الذي استولى على العاصمة، وهو اتفاق لو قُدّر له أن يتفعل، لما قامت الحرب، فمن نتائجه إعادة ترتيب الملف في ما له علاقة بتجديد الهيمنة والنفوذ في الجنوب الذي بات من الطبيعي أن يتفقوا على منحه بعض المكاسب الشكلية البسيطة لضمان بقائه في إطار هيمنة تحالف قوى الحكم والحليف الجديد (الحوثي)، ولكن عندما انفرط عقد ذلك الاتفاق لم يكن من خيار سوى أن يتمدد الحوثي جنوباً، خاصة أن خطابه الإعلامي كان يبدي نصرة لفظية لما يسميها (المظلومية) الجنوبية بحسب الخلفية الاصطلاحية التي يصدر عنها. وكان التصور أن تستعيد صنعاء هيمنتها جنوباً بواجهة جديدة (الحوثي) بعد أن تراجع نفوذ حزب صالح (المؤتمر الشعبي) وحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) المتفرع من حزب صالح نشأةً وتكويناً، لكن المواجهة عام 2015في عدن ومناطق الجنوب الأخرى لم تكن سلمية كما هي طبيعة الحراك الجنوبي منذ 2007 وإنما نظم الجنوب نفسه في مقاومة مسلحة كان تدخل قوات التحالف العربي (عاصفة الحزم) سنداً لها في اللحظة المناسبة، فبدت القضيتان الشمالية والجنوبية متوازيتين بوضوح في المشهد الراهن، وبدا الاصطفاف المتوازي دالاً على أهمية حل المسألة اليمنية حلاً جذرياً، كما جاء في الإفادة الأخيرة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى مجلس الأمن الدولي.
(4)
السؤال الذي يضع نفسه في ما له صلة بخلفيات الحرب الحالية في اليمن: لماذا تم تحرير الجنوب (عدن وماحولها) من قوات الحوثي وصالح في أسابيع، ثم تحرير حضرموت من القوات التي رفعت راية القاعدة وأنصار الشريعة وهي بالأصل قوات جيش علي صالح التي خلعت البزة العسكرية النظامية وارتدت زَيّ عناصر القاعدة ورفعت رايتها ليبقى نفوذ صالح بواجهة جديدة؟ وبموازاة هذا السوال: لماذا لم يحدث أي تقدم في جبهات القتال شمالاً باتجاه تحرير صنعاء واستعادة شرعية الدولة ممثلة بالرئيس التوافقي عبدربه منصور وحكومته المعترف بها دولياً؟
قد يبدو الجواب صعباً، فما يحدث معقد إلى درجة الاستغلاق على المراقب من الخارج، أو من يخطو على ضوء معطيات يتم تداولها في الخطاب الإعلامي والأدبيات السياسية المتداولة على أنها حقائق. غير أن الإجابة الأكثر قرباً إلى طبيعة ما يحدث هي أن الدوران حول المسألة اليمنية وعدم تشخيص طرفيها الرئيسين: القضية الشمالية والقضية الجنوبية بالمفهوم السياسي لا الجغرافي، هما اللذان يضللان المحلل والمراقب، ومن ثم يبعثان على الحيرة السياسية، بغض النظر على فاعلية دور اللاعب الإقليمي أو الدولي في هذه الحرب وما قبلها وما بعدها كجزء من الحالة العامة في المنطقة العربية.
فالواقع أن أطراف النزاع في القضية الشمالية تختلف في التفاصيل لكنها تتفق من حيث المبدأ والمصلحة على استبقاء الجنوب منطقة نفوذ وهيمنة تحت أي عنوان سياسي يتم الاتفاق عليه، وهي تتنازع على مقاعد السلطة في الشمال، لتحظى بالنصيب الأكبر من الثروة المتركزة أساساً في الجنوب (أكثر من 70% من ميزانية الحكومة اليمنية من عائدات نفط حضرموت مثلاً). لذلك فتحرير عدن وحضرموت ومناطق الجنوب الأخرى كان صادماً لتلك القوى التي توزعت بين ما يعرف بالشرعية والانقلاب، وفي الوقت الذي بدأ الجنوب يخطط لبناء ما دمرته الحرب وإعداد نفسه لطاولة تفاوض في أي تسوية سياسية لحل الأزمة اليمنية، ظل الحوثي وصالح مهيمنين على العاصمة بالتفاف شعبي، وبقيت قوات الشرعية تراوح مكانها، حتى لَيستعيد المراقب مشهد الحرب بين الجمهوريين والملكيين في ستينيات القرن الماضي، وما تعرض له أفراد الجيش المصري الداعم للجمهوريين من أسلوب الغدر والمخاتلة الموصوف بـ(في الصباح جمهوري وفي الليل ملكي)، بل لم يعد هاجس حكومة الشرعية تخليص صنعاء من قبضة الحوثي وإنما إخضاع المدن الجنوبية المحررة مرة أخرى لنفوذ قوى الهيمنة، فمارست أساليب مختلفة لافتعال أزمات تفرغ التحرير من مضمونه، وفي السياق نفسه ظلت تناور في علاقتها بالتحالف العربي بهدف الالتفاف على ما تحقق من انتصار جنوباً، هو الوحيد الذي يمكن عدّه إنجازاً ميدانياً لذلك التحالف على الأرض.
(5)
الشعب والمواطن البسيط في الشمال هو ضحية هذه الحرب التي طالت آثارها التدميرية البنية التحتية الهشة أصلاً، وتدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية والأمن والاستقرار، ناهيك عن الضحايا البشرية بنيران الطرفين (في صنعاء وتعز والحديدة على سبيل المثال). وعلى الجهة الموازية كانت الحرب جنوباً معركة لم يتم الاستعداد لها، لكنها أدت إلى رفع القدم الحديدية الجاثمة على الرقاب، وأنجز الجنوب عسكرياً ما لم يكن يستطيع إنجازه بالمواجهة السلمية التي كانت تواجَه بآلة القمع العسكرية، ولأول مرة منذ ما ترتب على حرب 1990 بدأ الجنوب يستعيد نفوذه على أرضه ويبني مؤسساته الأمنية والعسكرية التي تحمي المواطن والقانون ولا تستبد بهما تلبية لإرادة الحاكم في صنعاء. بمعنى أن من نتائج هذه الحرب على كل ويلاتها ومآسيها أنها أعادت التوازن العسكري والسياسي بين طرفي القضيتين الشمالية والجنوبية، وهو ما لم يتم بالسلم، بحيث إذا وضعت الحرب أوزارها فإن الطاولة السياسية، بعد تصفية الملعب من مخاتلة الأطراف المتنازعة على السلطة والثروة، ستجمع طرفين رئيسين فقط بينهما توازن عسكري وسياسي، لا ترجح فيه الكفة لمصلحة طرف مستقوٍ على حساب طرفٍ مستضعف كما كان الحال قبل الحرب.
(6)
اليمن إلى أين؟
ما بعد الحرب ليس ما قبلها، ولعل إعادة ترتيب أوراق الملف السياسي ستفضي إلى مرحل جديدة تنشأ فيها قوى سياسية متخففة من أعباء الماضي السياسي، في الشمال كما في الجنوب، من أجل التعايش الآمن بين طرفَي (المسألة اليمنية) وفق أي آلية يتم الاتفاق عليها بالتفاوض الندي، بعيداً عن الاستقواء والتحالفات السياسية التقليدية التي بنت استراتيجيتها على إدارة الأوضاع بالأزمات، وترحيل الأزمات بالدوران حول جوهر المسألة، وعندئذ سيلتقي الفرقاء من أجل المستقبل، لا الماضي وخرافاته التاريخية والسياسية والطائفية.