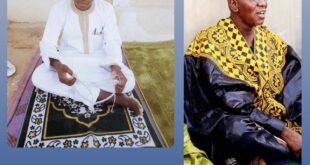جاءت هجمة «الحرب الهجين» (حروب الجيل الرابع) التى اجتاحت دول منطقة الشرق الأوسط بمثابة التدشين الفعلى لإستراتيجيات وتكتيكات جديدة تتعلق بشن الحروب بين الدول بأساليب جديدة تتماشى مع التطور التكنولوجى والمعلوماتى والاتصالى والاجتماعى والاقتصادى الذى يشهده العالم،وتمت الاستعانة بتلك التطورات كأدوات هجومية فى مواجهة الخصوم من جماعات أو دول أو أقاليم بأكملها.
وأخيرا أثار المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية، المتخصص فى الأبحاث السياسية والصراعات العسكرية، أمر صعوبة إستعانة الديمقراطيات الليبرالية (مسمى تحب دول الغرب أن تصف به نفسها) بـ «الحروب الهجين» كوسائل هجومية بشكل شامل ضد الخصوم ومدى خطورة الأمر على الدول التى تلجأ لاستخدام «الحروب الهجين» حيث يمكن أن يؤدى ذلك إلى نتائج عكسية تصيب الدولة المهاجمة ذاتها بالتخريب. وجاء التحذير فى وقت تعرضت فيه حروب «الحرب الهجينة» (حروب الجيل الرابع) للهزيمة فى مصر ولمأزق فى سوريا وليبيا قادت إلى أزمة تدفق اللاجئين والإطاحة بالديمقراطيين من واشنطن وتزايد خطر الهجمات الإرهابية فى الدول الغربية.
وكان قد ساد إعتقاد لدى الغرب منذ سنوات مضت بأن خطط «الحرب الهجينة» التى يضعها السياسيون والاقتصاديون وليس العسكريون هناك، تؤدى إلى تعرض البلد المهاجم الذى يستخدم الحرب الهجينة لأدنى الخسائر، ومع مرور الوقت يتوقف عن تحمل التكاليف المالية ويحول هذه النفقات إلى البلد الذى يتعرض للهجوم، محافظاً فى الوقت نفسه على أرواح جنوده. ولكن يبدو وبعد مرور ست سنوات من «التطبيق العملى» للحروب الهجين(حروب الجيل الرابع) فى الشرق الأوسط أدركت الجهات التى تتبنى شن هذا النوع من الحروب والمراكز البحثية التابعة مخاطر إرتداد تبعات تلك الحروب إلى قلوب من أطلقوها. وقد بدا ذلك بشكل واضح أثناء الإنتخابات الأمريكية عندما حسم المعسكر المضاد للحرب الهجين (دونالد ترامب) النتيجة لصالحه على حساب المعسكر الصانع والمؤيد للحروب الهجين (باراك أوباما وهيلارى كلينتون).
وقد أشار المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى مقال من إصداراته إلى أن هناك ثلاثة عوامل متشابكة تؤيد أن الديمقراطيات لايمكنها أن تشتبك فى «حرب هجين» ذات طابع هجومى لأن المسار سيؤدى إلى نتائج تصب فى صالح الأطراف السلطوية أو الأطراف من غير الدول. وجاءت العوامل التى تمت الإشارة إليها كما يلى:
أولا، أن الديمقراطيات الغربية قد تضطر إلى خوض نضال من أجل تنسيق عملية صنع القرار على مختلف مستويات السلطة بسرعة كبيرة. وستؤدى الضوابط والتوازنات إلى تعقيد تنفيذ عمليات ناجحة من «الحرب الهجين»، شأنها فى ذلك شأن المنافسة المؤسسية والبيروقراطية والتنافس الداخلى. وسيكون على الديمقراطيات أيضا أن تعمل ضمن إطار قانونى مشروع واضح المعالم، دون خرق حدود للنظام الدستورى الخاص بها وقواعد القانون الدولى. وفى حالة الحرب أو الطوارئ التقليدية يمكن تعليق أو وقف العمل بهذه القوانين مؤقتا، ولكن فى حالة «الحرب الهجين» فإنها فى كثير من الأحيان تحتل مساحة فى مكان ما فى المنطقة الرمادية بين السلم والحرب. وفى مثل هذه المناطق الرمادية سيكون على الديمقراطيات الليبرالية أن «تصارع» وسط صعوبات جمة لحشد المؤسسات العامة والدولة للمشاركة فى تلك الحرب.
ثانيا، تكون «الحرب الهجين» بمثابة التحدى للديمقراطيات من وجهة النظر الأخلاقية. فهناك بعض العناصر – مثل الإرهاب أو توظيف الجريمة المنظمة كوكلاء فى تلك الحرب – المصنفة على أنها خارج الحدود المسموح بها للديمقراطيات، مما يقلص من إستخدام الأدوات الخاصة بها من تكتيكات هجومية يمكن الإستعانة بها فى «الحرب الهجين». وحتى الإستعانة بأدوات مثل الدعاية المضادة فإنها تعد مشكلة من الناحية الأخلاقية. وعلى سبيل المثال، ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليان أن هذه التدابير لا تناسب «المجتمعات الحرة».
وعلاوة على ذلك، يكون على القادة فى تلك الدول الديمقراطية توليد والحفاظ على قدر من الدعم الشعبى لأعمالهم لإضفاء الشرعية وتبرير خياراتهم وقراراتهم التى يقومون باتخاذها فيما يتعلق بـ «الحرب الهجين». وفى عصر وسائل الاعلام الاجتماعية والوصول اللامركزى إلى المعلومات، فإن كل خطوة تتخذ من قبل الحكومات الغربية تكون عرضة للتفتيش الدقيق والإستجواب. وسيكون من الصعب على الحكومات الديمقراطية تحقيق الإستمالة الكاملة لوسائل الإعلام المحلية لإجراء عمليات المعلومات المرتبطة بـ»الحرب الهجين». وفى الوقت الذى يكون فيه تبنى التكتيكات الخاصة بحرب الهجين تحديا لشرعية الحكومات الديمقراطية فى بعض الحالات، فإنها فى كثير من الأحيان تمثل تحديا للمشروعية، على المستويين المحلى والدولى.
ثالثا، وأخيرا، تفتقد الديمقراطيات الغربية إلى الميزة النسبية فيما يتعلق بالإعتماد المتبادل على المستوى العالمى. فالمجتمعات الغربية تعتمد على البنية التحتية الدولية، وعلى الوصول إلى أسواق رأس المال والطاقة والموارد الطبيعية. وبالتالى فإن تحول هذه التدفقات العالمية إلى أسلحة فى الصراع دائما ما يحمل تكلفة المباشرة (مثل معركة البترول أثناء حرب 1973). وعلاوة على ذلك، فإن الحكومات الديمقراطية الغربية ستجد صعوبة فى الحصول على مساعدة من مؤسسات القطاع الخاص فى الجهود المتعلقة بـ»الحرب الهجين».
وتمت الإشارة إلى أنه ونظرا لهذه الثغرات الهيكلية، فإنه ليس من المستغرب أن الكثير من الطاقة الفكرية فى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى (ناتو) تنفق على الدفاع ضد التهديدات المتعلقة بـ»الحرب الهجين»، وليس حتى التفكير فى «الحرب الهجين» بشكل شامل. ومع ذلك، فإن جعبة تلك الدول الغربية ليست فارغة تماما. فالعمليات السرية واستخدام وكلاء فى الحرب بالوكالة – فى ظل ظروف معينة ـ يعد من الممارسات المستقرة المعمول بها. وخلط الوسائل العسكرية التقليدية بتكتيكات حرب العصابات التى تقوم بها قوات مدربة هو أيضا أمر ليس بعيد المنال. وبالاضافة إلى ما سبق فإن الديمقراطيات تمتلك أدوات المعلومات والدعاية المتطورة المعقدة، والتى يمكن إستخدامها بأساليب هجومية. فحتى «سياسة الإنكار»، فإنها تستخدم على سبيل المثال فى الفضاء الإلكترونى. ولكن عاد المقال الصادر عن المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية إلى التأكيد على أن إمتلاك الدول الغربية لكافة الأدوات سالفة الذكر (التى وصفها بالمحدودة) لا يعنى أنها قادرة على شن «الحرب الهجين» بطريقة شاملة ومنسقة مثل نظيراتها الدول الاستبدادية أو الأطراف من غير الدول. فإذا أقدمت الدول الغربية على شن هذا النوع من الحروب فإنه سيكون على حساب جوهر ما تسعى تلك الدول إلى الدفاع عنه من قيم ومكانة. و»الحرب الهجينة» عرفها الخبراء بأنها استراتيجية عسكرية تجمع بين الحرب التقليدية والحرب غير النظامية والحرب الالكترونية المعلوماتية. ويمكن تعريفها أيضا بأنها الهجمات التى تستخدم وسائل نووية وبيولوجية وكيميائية والعبوات الناسفة وحرب المعلومات. ويمكن إطلاق وصف الحرب الهجينة على الديناميكيات المعقدة فى ساحة المعركة التى تتطلب ردود فعل مرنة ومتكيفة. وخطط «الحرب الهجينة» يضعها السياسيون والاقتصاديون وليس العسكريون، ويتعرض البلد الذى يستخدم الحرب الهجينة لأدنى الخسائر، ومع مرور الوقت يتوقف عن تحمل التكاليف المالية ويحول هذه النفقات إلى البلد الذى يتعرض للهجوم، محافظاً فى الوقت نفسه على أرواح جنوده. ولدى خوض «الحرب الهجينة»، يستخدم ما يسمى بالهجوم المعلوماتى الذى يمكن أن يستمر لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، وفى هذه المرحلة تتشكل فى البلد الذى يتعرض للهجوم قوى معارضة السلطة من أعداد الشباب ذوى الميول المضادة للسلطة، ثم يجرى الضغط الخارجى من خلال الوسائل الاقتصادية، وذلك تمهيدا للثورة «الملونة» وتغيير النظام الحاكم. وكقاعدة، فإن استخدام الوسائل العسكرية يكون فى حده الأدنى، أو أنه يجرى تنفيذ عمليات «الحرب الهجين» على شكل هجمات موجهة عن بعد من دون استخدام قوات برية. وهكذا بدأ الغرب يعيد حساباته ويحصى خسائره بعد أن إرتبك فى سوريا التى شهدت القفزة الروسية الجيوإستراتيجية الكبرى وصمود الجيش السورى، وتقدم الجيش العراقى ونجاح الجيش الليبى فى السيطرة على مصادر البترول الليبى من يد المسلحين. ويقف مشهد تاريخى هام وراء كل ماسبق ..إنه مشهد جماهير الشعب المصرى 30 يونيو 2013.